| المشاركة رقم: #1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  1- قبسـات مِن الرسول [المقدمة والحديث الأول "فليغرسها"] 1- قبسـات مِن الرسول [المقدمة والحديث الأول "فليغرسها"] قَبَسَـاتٌ مِنَ الرسول صلى الله عليه وسلم(1) مقدمة الطبعة الشرعية الخامسة تصدر هذه الطبعة (عام 1398 ﻫ) ونحن على مقربة من نهاية القرن الرابع عشر الهجري وبداية القرن الخامس عشر.. وما أحوجنا - في هذه الفترة الدقيقة من حياتنا - أن نراجع مسيرتنا خلال تلك القرون، على ضوء الكتاب والسنة، اللذين أخرجا من قبل " خير أمة أخرجت للناس " واللذين هما معيار خيرية هذه الأمة. فعلى قدر استقامتها عليهما تتحقق خيريتها، وعلى قدر انحرافها عنهما تظل تنحدر حتى تصير إلى ذلك الغثاء الذي تحدث عنه الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يرى تلك الفترة العصيبة بنور الوحي: " يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا! إنكم كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل.. " واليوم تقوم - على هدي الكتاب والسنة كذلك - حركات بعث إسلامي في كل أرجاء العالم الإسلامي، يرجى أن تنقذ هذا الغثاء من وهدته، وتعيده (خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ). فما أحوجنا أن نتعرف على كتاب ربنا الكريم، وما أحوجنا كذلك أن نقبس "قبسات من الرسول" صلى الله عليه وسلم نقوّم بها ما أعوج في حياتنا من خطوات.. وما زلت أرجو أن يصدر مزيد من الكتب والدراسات التي يتناول فيها الكتاب سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وأحاديثه بالطريقة التي تقربها لهذا الجيل، وتقرب هذا الجيل كذلك من الإسلام. والله الموفق إلى ما فيه الخير. محمد قطب. مقدمة الكتاب لا أحسب أحداُ من البشر نال من الحب والإعجاب ما ناله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم, فإن أتباعه المؤمنين لا يمنعهم من تقديسه شيء إلا نهي الله لهم أن يتوجهوا بالعبادة والتقديس لأحد سواه. ومع ذلك فإن درجة الحب التي يتوجهون بها إلى الرسول r تكاد تفلت أحياناُ في قلوب بعض المسلمين فلا يمسكها هذا النهي إلا بجهد جهيد! وإن بعضهم لتصيبه حالات من الوجد في حب الرسول حتى لينسى نفسه، وتختلج مشاعره وقسمات وجهه، وتنهمر عيناه بالدموع، ثم لا يفيق من قريب! حتى بين " أجف " المسلمين قلباُ، وأغلظهم مشاعر (إن صح أنهم مسلمون مع ذلك!)، لن تجد منهم من لا يتوجه للرسول صلى الله عليه وسلم بالحب والتعظيم، ولو كان يعبد الله على حرف، ولا يقيم كثيراُ من قواعد الدين! أما غير أتباعه فقد هاجمه كثير منهم، ومع ذلك فإن أغلبية عظيمة من هؤلاء لم تملك نفسها من الإعجاب بشخصه، بصرف النظر عن دينه، فقالوا عنه إنه رجل عظيم، وقالوا إنه يملك الصفات التي تحبب إليه الناس. نعم.. لا أحسب أحداً من البشر نال من الحب والإعجاب ما ناله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك فإني أحسب أن كثيراً من المسلمين، وخاصة في هذه الأعصر الحديثة، لا يقدرون الرسول حق قدره، حتى وهم يتوجهون إليه بالحب، بل حتى وهم ينحرفون بهذا الحب إلى لون من التقديس! ذلك أنه حب سلبي لا صدى له في واقع الحياة! وإن صورة الرسول صلى الله عليه وسلم في قلوب هؤلاء المسلمين لتعاني عزلة وجدانية عميقة. إنه هنالك في أعمق أعماقهم. إنه روح نورانية شفيفة، إنه سنَى مشرق، إنه ومضات من النور الرائق والشعاع المتألق. إنه روح سارية في حنايا القلب وفي أنحاء الكون.. ومع ذلك فهو ليس حقيقة واقعة! إنه حقيقة " صوفية " منعزلة في الوجدان، واصلة إلى آخر أعماقه، ولكنه ليس صورة حية متحركة في واقع الحياة، شاخصة بلحمها ودمها، وأفكارها ومشاعرها، وتنظيماتها وتوجيهاتها، وهدمها وبنائها، ومادياتها وروحانياتها سواء! ولا شك أن لهذه العزلة أسباباً تاريخية... ففي عهد أبي بكر وعمر رضي الله عنهما لم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم منعزلاً في وجدان المسلمين. كان المسلمون قريبي العهد به، ما زالوا يعيشون مع ذكراه الحية في نفوسهم، وصوره الشاخصة في مخيلتهم، في غدوه ورواحه، وحربه وسلمه، وعبادته وعمله. صورة متكاملة تشمل الحياة كلها في أعماق الضمير وفي واقع المجتمع على السواء. ولكن قرب العهد لم يكن وحده السبب في إحساس المسلمين به حياً في نفوسهم، متكاملاً في مشاعرهم. وإنما كان إلى جانب ذلك سبب على أعظم جانب من الأهمية، هو امتداد تعاليم الرسول ومنهجه التربوي في تصرفات أبي بكر وعمر وطريقة سياستهما لأمور المسلمين. لقد أحس المسلمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم حي بتعاليمه ومنهجه، حتى وإن غابت ذاته الرفيعة عنهم في عالم الحس. وما عالم الحس من واقع النفس؟ إن الأشياء لا تقاس بوجودها أو عدم وجودها في عالم الحس. وإنما تقاس بمقدار ما توجد في عالم النفس، وبالمساحة التي تشغلها من المشاعر والأفكار والسلوك. ولا شك أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان " موجوداً " في نفوس المسلمين على عهد أبي بكر وعمر، وعلى مدار الأجيال التي لم تره بعد ذلك، أضعاف أضعاف ما كان موجوداً فـي نفس أبي جهل أو غيره من المشركين، ممن رأوه رأي العين، وجالدهم وجالدوه، ولكنهم لم يؤمنوا به، ولم يقووا على حبه فأبغضوه. وعلى هذا الأساس وحده نقيس وجود الرسول صلى الله عليه وسلم في نفوس المؤمنين وغير المؤمنين. وعلى عهد الشيخين كانت الحياة كلها محكومة بتعاليم الإسلام وروحه، وكان الشيخان على قمة البشرية بعد محمد صلى الله عليه وسلم ، يتطلع الناس إليهما في تصرفاتهما، وسلوكهما، ومشاعرهما، وأفكارهما فيدركون القبس الخالد الذي يقبسان منه، ويرون الرسول صلى الله عليه وسلم رأي الواقع في قلبيهما الكبيرين، فيعيشون في ظلهما مع الرسول فوق ما يعيشون معه في ذكرياتهم الخاصة، ووجداناتهم التي كانت بدورها قد شحنت بتلك القبسات المشرقة من قبسات الرسول. وجاء عثمان رضي الله عنه فسار في أول عهده على هدي الشيخين ما استطاع، ولكن رويداً رويداً أخذ نفوذ مروان بن الحكم ومنهجه يغلبان على الحكم، وعثمان رضي الله عنه تثقله السن. وبدأ المسلمون يحسون بافتراق الطريق. وبدأت الصورة المتكاملة للرسول صلى الله عليه وسلم تنحسر شيئاً فشيئاً إلى داخل النفوس، بعد أن كانت ملء النفوس وملء الحياة معاً وعلى نسق واحد. وكلما انفرجت الشقة بين الواقع المشهود وبين تعاليم الرسول صلى الله عليه وسلم وتوجيهاته، زادت صورتـه انحساراً في نفوس المسلمين، حتى ينتهي الأمـر إلى أن تصبح " مثالاً " متألقاً في أعماق الوجدان، لا صورة حية في العيان، مثالاً منعزلاً عن واقع الحياة، لا يحكمها ولا يرسم منهجها، ولا يتجه الشعور إليه لتسيير دفتها! ولكن أجيالاً متطاولة مضت قبل أن تتم العزلة في صورتها العنيفة التي تقوم اليوم في قلوب المسلمين. كان الحكم في البلاد الإسلاميـة - رغم بعده التدريجي عن روح الإسلام - يقوم باسم الإسلام! وكان المجتمع إسلامياً رغم فساد الحكام! نعم. لقد ظل المجتمع في الريف والمدن البعيدة عن العواصم إسلامياً قرابة ألف سنة، لا يتأثر بفساد الحكم، ولا تصل إليه العدوى من العاصمة المنحلة التي فيها القصور الماجنة، وصور الحياة الدنسة. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحكـم في العاصمة، ولا يرسم سياسة المال، ولكنه كان يُحكِم الروابط بين قلوب المسلمين في الريف والمدن البعيدة، فتقوم بينها محبة الإسلام وتكافل الإسلام وتراحم الإسلام، في الوقت الذي كانت " البيئة الزراعية " المماثلة في أوربا تقوم على علاقة السادة والعبيد: سادة لهم الأمر كله والملك كله، وعبيد ليس لهم من الأمر شيء سوى العبودية المطلقة والانعدام الذليل. في تلك الأثناء كانت بقية من صورته صلى الله عليه وسلم لم تنعزل بعد في وجدان المسلمين. ورغم أن المذاهب " الصوفية " كانت نشيطة في المجتمع الإسلامي كله في ذلك الوقت، والصوفية تجنح إلى العزلة عن الحياة والبعد عن مجالدتها، إلا أن هذه المذاهب قد أدت دوراً تاريخياً في منع المجتمع الإسلامي من التفكك، والإبقاء عليه مترابطاً " بأخوة " الصوفية كما أنها في غير قليل من الأحيان كانت تدخل معترك السياسة ولو من وراء ستار.. أما العزلة الكاملة الموحشة المرهوبة، فقد تمت وأحكمت حلقاتها حين بَعُدَ الحكم والمجتمع كلاهما عن الإسلام: اسمه وروحه، وصار الغرب هو الذي يحكم السياسة والمجتمع: باسمه الصريح حيناً، وعلى يد صنائعه النافرين من الإسلام حيناً آخر. وصار المجتمع الإسلامي صورة متحللة فاسدة من الأفكار الغريبة عن الحياة. لا هي إسلامية كما كانت، ولا هي نسيج واحد متميز، ولا تملك حتى القوة المادية التي يملكها الغرب، وإنما هي مسخ مشوه لا وحدة له ولا كيان. عندئذ لم يعد الرسول صلى الله عليه وسلم " موجوداً " أصلاً في واقع الحياة. لم يعد كياناً حياً شاخصاً بلحمه ودمه، وأفكاره ومشاعره، وتنظيماته وتوجيهاته، ومادياته وروحانياته.. وانحصر وجوده في مشاعر الناس السلبية، في أعمق أعماقها.. في حالات الوجد والهيام.. أصبح صورة.. مجرد صورة مثالية. لا يمسكها إلا الحب العنيف أن تكون أسطورة محلقة في الخيال! يا حسرة على العباد! كيف جاز لهم أن يصنعوا ذلك؟ كيف جاز لهم أن يبددوا أكبر طاقة بشرية كونية في هذا الوجود، فينحسروا بها في عزلة عن الحياة؟! وهل رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي يصنع معه هذا الصنيع؟ الرسول الذي كان طاقة حية متحركة فعالة هادمة بناءة لا تكف لحظة عن النشاط؟ الرجل الذي كان كله حياة في واقع الأرض، يصبح معزولاً عن واقع الأرض؟! وممن! من أتباعه ومحبيه! لو عاش صلى الله عليه وسلم في صومعته.. لو كان " فيلسوفاً " ممن ينشئون الأفكار ويعجزون عن التنفيذ.. لو كان ممن يحدثون عن " الأحلام " الجميلة و " المثل " الرفيعة ولا يبين لهم في واقع الأرض كيف تكون الطريق. لو أنه كان " شاعراً " أو " كاهناً "... لو أنـه كان شيئاً من هذا كلـه لجاز للناس أن يعزلـوه في وجدانهم، فيمنحـوه الحب "النظري " والإعجاب المجرد، ثم.. لا يلتفتوا إليه وهم يواجهون عالم الواقع ويضربون في مناكب الأرض. أما وهو الذي بين لهم كيف يضربون في مناكب الأرض.. أما وهو الذي أمسك المعول بيده فهدم الباطل أمام أعينهم وبنى بدله صرح الحق.. أما وهو الذي حارب معهم وأقام السلم.. وشيد بناء الدولة لهم لبنة لبنة حتى قام شاهقاً لا يطاوله بناء على الأرض.. وأكل معهم وشرب، وصحبهم وصحبوه، وعاش أمامهم كل لحظة من لحظات الحياة، وكل وجدان من وجداناتها وكل سلوك، ورأوه " يتصرف " في كل شأن من الشئون كبيرها وصغيرها، ليكون تصرفه سنة تحتذى، ويكون فيه أسوة حسنة للناس.. أما وهو هذا كله فأي جرم في تبديد هذه الطاقة البشرية الكونية الكبرى، وحصرها في داخل الوجدان؟! وهل جاء محمد صلى الله عليه وسلم لينعزل في الوجدان، والدين الذي جاء به هو الدين الذي يأبى الانعزال في الوجدان؟! إن أبرز سمة في هذا الدين أنه دين الظاهر والباطن على حد سواء. لا يرضى أن يكون الظاهر نظيفاً والباطن غير نظيف، فيصبح رئاء الناس. ولا يرضى أن يكون الباطن نظيفا ولا صدى له في الظاهر فيفقد مهمته ومعناه. إنه الدين الذي يجعل العمل عبادة.. ورسوله صلى الله عليه وسلم هو الرسول الذي ظل حياته كلها يتعبد بالعمل.. العمل المثمر النافع الظاهر للعيان. فكيف جاز بعد هذا كله أن يتحول في قلوب المسلمين إلى مثال منعزل، ولو كان أرفع مثال على الأرض وأنبل مثال؟! * * * ولقد كان إحساسي بالرسول الكريم دائماً هو إحساسي بالواقع المجسم، لا بالخيال المحلق في الفضاء. وكانت تهز وجداني هزاً عنيفا هذه الصورة المعروفة في كتب السيرة كلما قرأتها: " كان يمشي وكأنه يتقلع من الأرض... " وترتسم في خيالي صورة رائعة، حية شاخصة، ممتلئة بالحيوية، متوفزة النشاط.. عظيمة في هذا كله عظمة لا تحد. وانظر إلى الصورة التي تجسمت في خيالي فأرى النور الرائق الصافي يشع من أعماق روحه صلى الله عليه وسلم، وينفذ إلى أعماق نفسي، ويغلبني الوجدان وأنا أنظر إلى هذه الروح الصافية العميقة الشفافة المشعة، ومع ذلك فلا تلبث صورته أن تتحرك.. وأراه صلى الله عليه وسلم يمشي وكأنه يتقلع من الأرض. أراه.. بمقدار ما تطيق روحي أن تصل إليه.. متحركاً يضرب في مناكب الأرض، ويشق طريقه في قوة وثبات وتمكن، ويقيم البناء كله لبنة لبنة.. وأراه في مواقفه النفسية الدقيقة العميقة، فأكاد ألمس النفس الجياشة المتحركة الدافقة. وأراه في لحظات تعبده، والنور يتألق من روحه ومن طلعته، فأحس كأن هذا النور يتحرك.. يتحرك ممتداً حتى يشمل الفضاء. الحركة الحية المتوفزة هي في نفسي صورة الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن ثم لا أحس بها منعزلة في الوجدان.. ثم أرى العزلة التي تعانيها صورته في وجدان المسلمين، فأعجب للناس كيف يحبونه كل هذا الحب، ثم لا يتدبرون حياته للقدوة والأسوة كما قال لهم ربهم في كتابه المبين؟! * * * وليس هذا كتاباً في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم! وإنما هو جهد متواضع كل همي منه أن أحاول إخراج صورة الرسول من عزلتها الموحشة في قلوب المسلمين. هدفي أن أقول للناس تدبروا بعض أقوال الرسول r ، وانظروا كيف كانت كل كلمة يقولها منهج تربية ومنهج سلوك ومنهج تفكير ومنهج حياة.. إنها مختارات متفرقة من الأحاديث، أو " قبسات من الرسول " كما أسميتها، كل منها يصلح أن يكون أحد " مفاهيم " الإسلام، مفاهيمه الواقعية الضاربة في مناكب الأرض، المتلبسة بصميم الحياة. وليست هذه المختارات استقصاء لكل المفاهيم، ولا استقصاء لكل ما قيل في أي من هذه المفاهيم. وإنما هي مجرد مختارات كتبتها كما خطرت ببالي، وحسبي منها أن تفتح الطريق. اللهم وفقني.. وأوزعني أن اشكر نعمتك التي أنعمت عليَّ.. إني لما أنزلت إليَّ من خير فقير.. فليغرسها "إن قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة، فاستطاع ألا تقوم حتى يغرسها، فليغرسها فله بذلك أجر"[1]. ولعل آخر ما كان يدور في ذهن السامعين أن يقول لهم الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك الحديث! ولعلهم توقعوا أن يقول لهم الرسول الذي جاء ليذكر الناس بالآخرة، ويحثهم على العمل لها، ويدعوهم إلى تنظيف ضمائرهم وسلوكهم من أجل اليوم الأكبر: يوم الحساب الذي تدان فيه النفوس.. لعلهم توقعوا أن يقول لهم: فليسرع كل منكم فليستغفر ربه عما قدمت يداه، وليتوجه لله بدعوة خالصة أن يميته على الإيمان ويقبل توبته ويبعثه على الهدى.. ولعلهم توقعوا أن يقول لهم: أسرعوا فانفضوا أيديكم من تراب الأرض.. وتطهروا. اتركوا كل أمور الدنيا وتوجهوا بقلوبكم إلى الآخرة. انقطعوا عن كل ما يربطكم بالأرض. اذكروا الله وحده. توجهوا إليه خالصين من كل رغبة في الحياة، حتى إذا ذهبتم إلى ربكم، ذهبتم وقد خلصت نفوسكم إليه، فيقبل أوبتكم ويظلكم بظله، حيث لا ظل إلا ظله. ولو قال لهم ذلك فهل من عجب فيه؟! أليس الطبيعي وقد تيقن الناس من القيامة أن ينصرفوا للحظة المرهوبة؟ أليس الطبيعي والهول المهول على الأبواب أن ينسلخ الناس من كل وشيجة تربطهم بالأرض، ويتطلعوا في رهبة الخائف وذهول المرتجف إلى قيام اليوم الذي تذهل فيه كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، ولكن عذاب الله شديد؟! فإذا قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تقفوا مذهولين مرجوفين مرعوبين، ولكن توجهوا إلى الله أن ينقذكم من هذا الكرب العظيم، أخلصوا له الدعاء فهو قريب يجيب دعوة الداعي إذا دعاه. (ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون). هلموا تطهروا، وصلوا إلى الله خاشعين.. إذا قال لهم الرسول ذلك وضع البلسم الشافي على الأرواح المكلومة. وقد وضع يده الحانية يربت بها على النفوس المهتزة المزلزلة الراجفة فتطمئن. وقد فتح الكوة التي يطل منها على القلوب المكفهرة المذعورة بصيص الأمل والأمن والرجاء.. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقل شيئاً من ذلك كله الذي توقعه السامعون. بل قال لهم أغرب ما يمكن أن يخطر على قلب بشر! قال لهم: "إن كان بيد أحدكم فسيلة فاستطاع أن يغرسها قبل أن تقوم الساعة فليغرسها.. فله بذلك أجر"! يا ألله! يغرسها؟! وما هي؟ فسيلة النخل التي لا تثمر إلا بعد سنين؟ والقيامة في طريقها إلى أن تقوم؟ وعن يقين؟! يا الله! لن يقول هذا إلا نبي الإسلام خاتم النبيين! الإسلام وحده هو الذي يمكن أن يوجه القلوب هذا التوجيه، ونبي الإسلام وحده هو الذي يمكن أن يهتدي هذا الهدي، ويهدي به الآخرين! وهذا تاريخ الأرض كلها.. ليس فيه مثل هذه القبسة من قبسات الرسول! * * * وهي كلمة بسيطة لا غموض فيها، ولا صنعة، ولا " تفنن ". كلمة - رغم غرابتها لأول وهلة، وبدهها للفكر على غرة - تخرج بسيطة كبساطة الفطرة، عميقة كعمق الفطرة، شاملة واسعة فسيحة، تضم بين دفتيها منهج حياة.. منهج الحياة الإسلامية. كم من معنى تستخلصه النفس من الكلمات البسيطة العميقة في آن. أول ما يخطر على البال هو هذه العجيبة التي يتميز بها الإسلام: أن طريق الآخرة هو طريق الدنيا بلا اختلاف ولا افتراق! إنهما ليسا طريقين منفصلين: أحدهما للدنيا والآخر للآخرة!! وإنما هو طريق واحد يشمل هذه وتلك، ويربط ما بين هذه وتلك. ليس هناك طريق للآخرة اسمه العبادة. وطريق للدنيا اسمه العمل! وإنما هو طريق واحد أوله في الدنيا وآخره في الآخرة. وهو طريق لا يفترق فيه العمل عن العبادة ولا العبادة عن العمل. كلاهما شيء واحد في نظر الإسلام. وكلاهما يسير جنباً إلى جنب في هذا الطريق الواحد الذي لا طريق سواه! العمل إلى آخر لحظة من لحظات العمر. إلى آخر خطوة من خطوات الحياة! يغرسها والقيامة تقوم تقوم هذه اللحظة. عن يقين! وتوكيد قيمة العمل، وإبرازه والحض عليه، فكرة واضحة شديدة الوضوح في مفهوم الإسلام. ولكن الذي يلفت النظر هنا ليس تقدير قيمة العمل فحسب، وإنما هو إبرازه على أنه الطريق إلى الآخرة الذي لا طريق سواه. وقد مرت على البشرية فترات طويلة في الماضي والحاضر، كانت تحس فيها بالفرقة بين الطريقين. كانت تعتقد أن العمل للآخرة يقتضي الانقطاع عن الدنيا، والعمل للدنيا يزحم وقت الآخرة! وكانت هذه الفرقة بين الدنيا والآخرة عميقة الجذور في نفس البشرية، لا تقف عند هذا المظهر وحده، وإنما تتعداه إلى مفاهيم أخرى تتصل بالكيان البشري في مجموعه. فالدنيا والآخرة مفترقتان. والجسم والروح مفترقان. والمادي يفترق عن " اللامادي ". والفيزيقا - بلغة الفلاسفة - تفترق عن الميتافيزيقا. والحياة العملية تفترق عن الحياة المثالية أو عن مفاهيم الأخلاق. إلى آخر هذه التفرقات التي تنبع كلها من نقطة واحدة، هي التفرقة بين الدنيا والآخرة، أو بين الأرض والسماء. وحين تعيش البشرية على هذه الفكرة المفرقة الموزعة، تعيش ولا جرم في صراع دائم محير مضلل. تعيش موزعة النفس منهوبة المشاعر. لا تحس بوحدة تجمع كيانها، أو رابط يربط أشتاتها. فلا تعرف الراحة ولا تعرف السلام. والفرقة بين الأهداف المتعارضة شقوة قديمة وقعت فيها البشرية وما تزال واقعة. وقد كانت تؤدي في القديم إلى عزلة بعض الناس وتنسكهم، وتكالب آخرين على الحياة يجعلونها همهم الأوحد، ينتهبون ما فيها من متعة قبل وقت الفوات، فتملكهم شهواتهم ولا يملكون نفسهم منها، وتقتلهم في نهاية الأمر.. يستوي أن توردهم موارد الحتف، أو تشقيهم بالتعلق الدائم الذي لا يهنأ ولا يستقر. وما تزال هذه الفرقة تؤدي إلى نتائجها تلك في العالم الحديث. ولكنها تزيد في " مدنيتنا " الحاضرة حتى تبلغ مبلغ الجنون! وحالات الهستريا، وضغط الدم واضطراب الأعصاب، والجنون الكامل، والانتحار.. تتزايد في ظل الحضارة الحديثة إلى درجة خطرة تؤذن بتدمير الطاقة البشرية وتفتيتها، وهي صدى لتلك الفرقة التي توزع النفس الواحدة في وجهات شتى ثم لا تربط بينها برباط [2]. والكيان النفسي بحكم فطرته التي فطره الله عليها.. وحدة. وحدة تشمل الجسم والعقل والروح. تشمل " المادة " و " اللامادة " تشمل شهوات الجسد ورغبات النفس وتأملات العقل وسبحات الروح. تشمل نزوات الحس الغليظة وتأملات الفكر الطليقة ورفرفات الروح الطائرة. ولا شك أن جزئيات هذا الكيان متعارضة، وأن كلاً منها جانح في اتجاه.. ذلك إذا تركت وشأنها، ينبت كل نابت منها على هواه! ولكن العجيبة في هذا الكيان البشري، عجيبة الفطرة التي فطره الله عليها، أن هذا الشتات النافر المنتثر، يمكن أن يجتمع، يمكن أن يتوحد، يمكن أن يترابط، ثم يصبح - من عجب - في وحدته تلك وترابطه، أكبر قوة على الأرض! ذلك حين تقبس الذرة الفانية من حقيقة الأزل الخالدة، فتشتعل وتتوهج، وتصبح طليقة، كالنور.. تمتزج فيها المادة واللامادة فهما سواء! والطريق الأكبر لتوحيد هذا الشتات النافر المنتثر، وربطه كله في كيان، هو توحيد الدنيا والآخرة في طريق! عندئذ لا تتوزع الحياة عملاً وعبادة منفصلين. ولا تتوزع النفس جسماً وروحاً منفصلين. ولا تتوزع الأهداف عملية ونظرية، أو واقعية ومثالية لا تلتقيان! حين يلتقي طريق الدنيا بطريق الآخرة، وينطبقان فهما شيء واحد، يحدث مثل هذا في داخل النفس، فتقترب الأهداف المتعارضة. ويلتقي الشتات المتناثر، ثم ينطبق الجميع فهو شيء واحد. وتلتقي النفس المفردة - بكيانها الموحد - تلتقي بكيان الحياة الأكبر، وقد توحدت أهدافه وارتبط شتاته، فتتلاقى معه، وتستريح إليه، وتنسجم في إطاره، وتسبح في فضائه كما يسبح الكوكب المفرد في فضاء الكون لا يصطدم بغيره من الأفلاك، وإنما يربطها جميعاً قانون واحد شامل فسيح. والإسلام يصنع هذه العجيبة! ويصنعها في سهولة ويسر! يصنعها بتوحيد الدنيا والآخرة في نظام. (وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا) [3]. (قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ) [4]. وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم الترجمة الكاملة الصادقة للحقيقة الإسلامية. ومن ثم كانت الدنيا والآخرة في نفسه طريقاً واحداً ونهجاً واحداً و " حسبة " واحدة. أي عمل من أعماله صلى الله عليه وسلم لم يكن مقصوداً به وجه الله والآخرة؟ وأي لحظة كف صلى الله عليه وسلم عن العمل في الدنيا، والعمل لإصلاح الأرض؟ حتى الصلاة.. ألم يكن صلوات الله وسلامه عليه يستعين فيها الله أن يمكنه من أداء رسالته على الوجه الأكمل، ورسالته هي هداية الناس في الأرض، ليعرفوا الله واليوم الآخر؟! حلقة واحدة لا تنقطع: العمل والعبادة، والدنيا والآخرة، والأرض والمساء! والرسول صلى الله عليه وسلم هو القدوة والأسوة الحسنة، وهو واضع المنهاج العملي لتحقيق الإسلام في عالم الواقع. والرسول صلى الله عليه وسلم لم يعتزل الناس ليتطهر لربه في معزل. فعباداته يقضيها أمامهم ومعهم وهم في صحبة منه. فإذا كان يخلو إلى ربه في جنح الليل يتعبد، فكل نفس بشرية تهفو إلى الخلوة حيناً من الوقت، وكل نفس تملك أن تصفو في هذه الخلوة فوق ما تصفو في حضرة الآخرين. ولكن المهم أنه في أعمق خلواته وأصفاها لا ينسى أنه رسول الله، المكلف بأداء رسالة الله. والرسول يحارب في سبيل الله. ويسالم في سبيل الله. ويدعو الناس إلى سبيل الله. ويأكل باسم الله. ويتزوج على سنة الله. ويهدم ويبني، ويحطم وينشئ، ويهاجر ويتوطن.. كل ذلك في سبيل الله، واليوم الآخر، يوم يلقى الله. فكل عمله إذن عبادة يتوجه بها إلى الله. والطريق أمامه طريق واحد.. هو الطريق إلى الله... وهو يسير في هذا الطريق الأوحد الذي لا طريق غيره، يسير قدماً لا يتلفت ولا يتحول.. ولا يكف عن المسير.. إلى آخر لحظة من حياته صلى الله عليه وسلم كان يسير في الطريق. كان يعمل في الدنيا وهو يبغي الآخرة، ويعمل للآخرة بالعمل في الأرض. حتى حين نزلت الآية: (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْأِسْلامَ دِيناً) وأحس عمر رضي الله عنه أنها النهاية فدمعت عيناه.. حتى في مرض الموت.. حتى في اللحظة الأخيرة لم يزايله انشغاله بأمور الدنيا.. بأمور الناس.. بإصلاح الأرض.. بهداية البشرية.. برسم المنهج الذي يسيرون عليه.. بتوطيد أركان الدين وتوثيق عراه.. وكان يقول والوجع يشتد عليه صلى الله عليه وسلم: " إيتوني بكتاب أكتب لكم كتاباً لا تضلوا بعده أبداً.. ". كانت في يده الفسيلة وكان يغرسها.. ولم يدع يديه منها صلى الله عليه وسلم حتى فاضت روحه الكريمة الطاهرة إلى مولاه.. * * * وإن في ذلك لدرساً يقتدي فيه المسلمون بنبيهم، ويهدون به البشرية الضالة إلى سواء السبيل. يتعلمون أن يربطوا طريق الدنيا بطريق الآخرة. يتعلمون أن الدين ليس عزلة عن الحياة، وإنما هو صميم الحياة. ليس عزلة عن تيار الحياة الصاخب المضطرب فلا يركبون فيه مركبهم مع الراكبين. وأنهم لا يرضون ربهم ولا يخدمون دينهم إذا أحسوا أنه ينبغي عليهم أن ينسوا الله والدين إذا دخلوا معترك الحياة وعملوا لإصلاح الأرض. لن يرضوا الله ولن يخدموا الدين إذا دخلوا المدرسة أو الجامعة أو المعمل أو المصنع أو المتجر وفي حسابهم أنهم الآن يعملون للأرض ويعملون للدنيا، وأنهم في لحظة أخرى حين يفرغون من عمل الأرض سيعودون - إذا عادوا - إلى الله، فيعبدونه ويتوجهون إليه! كلا! ليس ذلك من الإسلام! إنما الإسلام أن يأكلوا باسم الله، ويتزوجوا باسم الله، ويتعلموا باسم الله وفي سبيل الله، ويعملوا وينتجوا ويتقووا ويستعدوا.. في سبيل الله. لا تشغلهم الدنيا عن الآخرة، ولا الآخرة عن الدنيا، لأنهما طريق واحد لا يفترقان. وحين يتعلم المسلمون ذلك: حين يتعلمون أنهم إذا درسوا الطاقة الذرية واستخدامها في السلم والحرب يمكن أن يكونوا متصلين بالله وفي سبيل الله. حين يتعلمون أنهم وهم يدرسون النظم السياسية والاقتصادية والإصلاح الاجتماعي، أو يطبقونها على الناس وهم يسوسون أمورهم، يمكن أن يكونوا متصلين بالله وفي سبيل الله. حين يتعلمون أنهم وهم في خلوتهم مع أزواجهم يحققون هدف الحياة الأكبر، يمكن أن يذكروا اسم الله ويكونوا في سبيل الله.. حين يتعلمون أن عملاً واحداً من أعمال الأرض الكثيرة المتفرقة لا يمكن أن يخرج عن الطريق إلى الآخرة إذا أقدم عليه الإنسان وهو مسلم مؤمن بالله متوجه إلى الله.. بل حين يتعلمون أنه لا يمكنهم أن يخدموا الآخرة إلا بإصلاح الدنيا، ولا يصلوا للآخرة إلا عن طريق الأرض، وأن عليهم أن يظلوا إلى آخر لحظة من حياتهم يعمرون الأرض ويغرسون فسائلها، وإلا فلن يصلوا إلى رضوان الله.. حين ذلك يكونون مسلمين حقاً.. وحين ذلك يكونون قدوة للأمم كلها على سطح الأرض، كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم هو قدوتهم. (لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيداً عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ). عندئذ يكون لديهم ما يعلمونه للعالم كله، وللغرب المفتون خاصة. الغرب الذي أصابه الجنون فقام بحربين متواليتين في ربع قرن، وهو اليوم يستعد لتدمير الأرض! يستطيعون أن يقولوا للناس في كل الأرض: لقد ألغيتم " الله " من حسابكم لأنكم ظننتم أنه يعوّقكم عن تعمير الأرض، وعن تعلم العلم، وعن استغلال طاقة الأرض، وعن الاستمتاع بالحياة! ولكنه في الواقع ليس كذلك! إنه يدعو إلى كل هذا الذي تهفون إليه: (قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ) وإنما يريد فقط أن توحدوا طريقكم، فلا تجعلوا طريقاً للدنيا وطريقاً للآخرة منفصلتين، وإنما طريق واحدة للدنيا والآخرة، هي الطريق إلى الله. * * * وليس هذا هو الدرس الوحيد الذي نتعلمه من هذا الحديث العجيب. فلا يأس مع الحياة! والعمل في الأرض لا ينبغي أن ينقطع لحظة واحدة بسبب اليأس من النتيجة! فحتى حين تكون القيامة بعد لحظة، حين تنقطع الحياة الدنيا كلها، حين لا تكون هناك ثمرة من العمل.. حتى عندئذ لا يكف الناس عن العمل وعن التطلع للمستقبل، ومن كان في يده فسيلة فليغرسها! إنها دفعة عجيبة للعمل والاستمرار فيه والإصرار عليه! لا شيء على الإطلاق يمكن أن يمنع من العمل! كل المعوقات.. كل الميئسات.. كل " المستحيلات ".. كلها لا وزن لها ولا حساب.. ولا تمنع عن العمل. وبمثل هذه الروح الجبارة تعمر الأرض حقاً وتشيد فيها المدنيات والحضارات. كل ما في الأمر أن الإسلام وهو يدعو لتعمير الأرض، والعمل في سبيلها، لا ينحرف بالأفكار والمشاعر عن طريق الله وطريق الآخرة، لأنه لا يفصل بين الدنيا والآخرة، ولا بين الحياة العملية و" الأخلاق ". إنه لا يقول - كما يقول الغرب المنحرف - فلأعمر الأرض، ولا يعنيني أن ترتفع أخلاق الناس أو تهبط، فللعمل مقاييس وللأخلاق مقاييس! لا تهمني أخلاق الرجل ما دام " إنتاجه " يعجبني! فهذه النظرة المبتسرة الهابطة لا تلبث أن تدمر في لحظة ما بنته في أجيال. وأن تحيل العمار كله إلى خراب! بل إن هذه النظرة المبتسرة الهابطة لتوزع النفوس والأفكار بين الخير والشر، وبين الواقع والمثال، فتكون النتيجة القريبة هي الأمراض العصبية والجنون والانتحار، وذلك وحده تدمير للنفوس وتبديد للطاقة، ولو لم يحدث الدمار الشامل والخراب الرهيب. وقد كان المسلمون وهم يؤمنون بدينهم ويعملون به يبنون أروع حضارات الأرض وينشئون أرفع مفاهيمها.. ولا ينحرفون عن طريق الله. كانت طاقة " العمل " تدفعهم للإنشاء والتعمير، والفتح والانسياح في الأرض، فبلغوا في لمحة خاطفة من الزمن ما لم يبلغه غيرهم في قرون، وأقاموا في كل مكان مثلاً للعدالة الإنسانية كانت - وما تزال - غريبة على البشرية، ينظرون إليها كما ينظرون للأحلام والأساطير. حين أعاد أبو عبيدة الجزية لأهل الشام يوم علم باحتشاد جيش الروم وخشي ألا يقدر على حمايتهم، وقال لهم: " إنما رددنا عليكم أموالكم لأنه بلغنا ما جمع لنا من الجموع. وإنكم قد اشترطتم علينا أن نمنعكم، وإنا لا نقدر على ذلك. وقد رددنا عليكم ما أخذنا منكم ونحن لكم على الشرط وما كتبنا بيننا وبينكم إن نصرنا الله عليهم ". حين صنع ذلك كان يقوم بإحدى المعجزات التي أنشأها الإسلام على وجه الأرض. يعمل. ويجتهد في عمله إلى أقصى الغاية، ويضرب في مناكب الأرض. ويحارب ويغزو. ولا ينسى الله لحظة واحدة في ذلك كله ولا يفترق طريقه في الدنيا عن طريقه إلى الآخرة، لأنه يعمل ذلك كله في سبيل الله. وحين تم النصر لصلاح الدين في الحروب الصليبية وأمكنه الله من أعداء دينه الذين غدروا من قبل بعهد الله، وذبحوا المسلمين داخل البيت المقدس، واعتدوا بغلظة ووحشية على كل حرمات البشرية.. لم يثأر لنفسه، ولم يمثل بهم، ولم يعمل في رقابهم السيف - وهو مأذون بذلك من كل شرائع السماء والأرض معاملةً بالمثل - بل صفح وعفا، وارتفع على نفسه وعلى النفس " البشرية " كلها.. حين ذلك كان يقوم بمعجزة أخرى من معجزات الإسلام.. يعمل ويعمل.. ولا ينسى الله، ولا يفترق طريقه في الأرض عن طريقه إلى الآخرة. وبذلك كان الإسلام فذاً في التاريخ.. وكان البناء الذي بناه الإسلام فريداً بالرغم مما أصابه من ضربات من الداخل ومن الخارج على السواء. لقد كان المسلمون يقتدون برسولهم وهو يحثهم على العمل لتعمير الأرض، وغرس ما في أيديهم من فسائل تثمر حين يشاء لها الله، وإنما عليهم فقط أن يغرسوها، ويمضوا إلى غيرها يغرسون في مكان جديد! ويقتدون به فيغرسون به ما يغرسون من نبتات الخير في كل مكان، وهم يتجهون إلى الله وحده وإلى الآخرة. لا تدفعهم مطامع الأرض المنبتة عن طريق الله، ولا شهوات النفس المنبتة عن تقوى الله. وبذلك تميزوا وسادوا، وكانوا النور المشرق في ظلمات الأرض، والقدوة في كل سوك وكل عمل وكل علم وكل نظام. وأوربا في ظلمة الجاهلية تأكلها الفرقة والحروب والتأخر والانحطاط.. حتى قبست قبسات من الإسلام في الحروب الصليبية، فأفاقت من غفوتها وبدأت " تنهض ".. ولكن على غير طريق الله وطريق الآخرة.. ومن ثم لا تقوم إلا كمن يتخبطه الشيطان من المس.. تنطلق كالمجنون والهوة في آخر الطريق. وإن أمام المسلمين الكسالى اليوم قدوة في رسول الله تنفعهم إذا فتحوا لها بصائرهم وتدبروا معانيها. إن عليهم أن يعملوا دائماً ولا يكلّوا.. يعملوا جهد طاقتهم، وفوق الطاقة ليعوضوا القعود الطويل. يعملوا في كل ميدان من ميادين العمل: في ميدان العلم وميدان الصناعة وميدان التجارة وميدان الاقتصاد وميدان السياسة وميدان الفن وميدان الفكر.. يعملوا ولا يقولوا: ما قيمة العمل؟ وماذا يمكن أن نصل إليه؟ يغرسوا الفسيلة ولو كانت القيامة تقوم اللحظة. فإنما عليهم أن يعملوا، وعلى الله تمام النجاح! * * * والدعاة خاصة لهم في هذا الحديث درس أي درس! فالدعاة هم أشد الناس تعرضاً لنوبات اليأس، وأشدهم حاجة إلى الثبات! قد ييأس التاجر من الكسب، ولكن دفعة المال لا تلبث أن تدفعه مرة أخرى إلى السير في الطريق. قد ييأس السياسي من النصر، ولكن تقلبات السياسة لا تلبث أن تفتح له منفذاً فيستغله لصالحه. قد ييأس العالم من الوصول إلى النتيجة.. ولكن المثابرة على البحث والتدقيق كفيلة أن توصله إلى النهاية. كل ألوان البشر المحترفين حرفة معرضون لليأس، وهم في حاجة إلى التشجيع الدائم والحث الطويل، ولكنهم مع ذلك ليسوا كالدعاة في هذا الشأن، فأهدافهم غالباً ما تكون قريبة، وعوائقهم غالباً ما تكون قابلة للتذليل. وليس كذلك المصلحون. إنهم لا يتعاملون مع المادة ولكن مع " النفوس " والنفوس أعصى من المادة، وأقدر على المقاومة وعلى الزيغ والانحراف. والسم الذي يأكل قلوب الدعاة هو انصراف الناس عن دعوتهم، وعدم الإيمان بما فيها من الحق، بل مقاومتها في كثير من الأحيان بقدر ما فيها من الحق، وعصيانها بقدر ما فيها من الصلاح! عندئذ ييأس الدعاة.. ويتهاوون في الطريق. إلا من قبست روحه قبسة من الأفق الأعلى المشرق الطليق. إلا من أطاقت روحه أن يغرس الفسيلة ولو كانت القيامة تقوم اللحظة عن يقين! * * * الدعاة أحوج الناس إلى هذا الدرس. أحوج الناس أن يتعلموا عن الرسول صلى الله عليه وسلم هذا التوجيه العجيب الذي تتضمنه تلك الكلمات القليلة البسيطة الخالية من الزخرف والتنسيق. هم أحوج الناس أن يقبسوا من قبسات الرسول هذه اللمحة المضيئة الكاشفة الدافعة الموحية، فتنير في قلوبهم ظلمة اليأس، وتغرس في نفوسهم نبتة الأمل، كما تغرس الفسيلة في الأرض لتثمر بعد حين. إنه يقول لهم: ليس عليكم ثمرة الجهد، ولكن عليكم الجهد وحده، ابذلوه ولا تتطلعوا إلى نتائجه! ابذلوه بإيمان كامل أن هذا واجبكم وهذه مهمتكم، وأن واجبكم ومهمتكم ينتهيان بكم هناك، عند غرس الفسيلة في الأرض، لا في التقاط الثمار! وهو إذ يقول لهم ذلك لا يغرر بهم ولا يضحك عليهم! إنما يقول لهم الشيء الواحد الصواب! فحين تسأل نفسك: متى تثمر الفسيلة وكيف تثمر، وحولها الرياح والأعاصير والشر من كل جانب؟ وحين يصل بك التفكير إلى أن تطرح الفسيلة جانباً وتنفض منها يديك.. حينئذ كيف تثمر؟ وأنَّى لها أن تعيش؟ أما قتلتها أنت حين أفلتّها من يديك؟ ولكنك حين تغرسها في الأرض وترفع يديك لله بالدعاء.. حينئذ تكون أودعتها مكانها الحق، وعهدت بها إلى الحق الذي يرعاها ويرعاك. ولا يشغلك أن تسأل: متى تكون الثمار؟! ليس هذا من عملك أنت. لست مهيمناً على الأقدار. وليس لك علم الغيب. و لا في طوقك - لو علمته - أن تمسك نفسك من الدوار! ومن تكون أنت في ملك الله الواسع الفسيح الذي لا حد له ولا انتهاء؟! وإنما أنت أنت: مخلوق حي متحرك له كيان وله وزن وقوة ومكان في تاريخ الأرض، حين تقبس روحك قبسة من صانع الأرض وصانع الكون، وصانعك أنت من بين هذا الكون الكبير. أفلا تدع له إذن مصيرك مطمئناً إليه؟ أو لا تدع له كذلك هذه الفسيلة التي غرستها يرعاها لك ويطلع لها الثمار؟! أو لا تكتفي بدورك المطلوب منك في الملكوت الهائل الفسيح، وتحمد الله أن لم يحمّلك سوى دورك هذا المحدود الميسور؟! وحين تصنع ذلك تطلع الثمار! لا عجب في ذلك ولا سحر! وإنما أنت تؤدي دورك وتمضي، فيجيء غيرك فيعجب بك وما صنعت، فيحبك، فيذهب يتعهد فسيلتك التي غرست، فتنمو، وتطلع الثمار. وقد تكون " سعيداً " بمقاييس الأرض، فترى الثمرة وأنت حي في عمرك المحدود. وقد تمضي قبل أن ترى الثمار.. ولكن أين تمضي؟ هل تمضي لأحد غير الله، إلى جوار غير جوار الله؟ فماذا إذن عليك حين تصل إلى هناك، أن تكون قد رأيت الثمرة هنا، أو تراها وأنت هناك؟ كلا! إنهما في النهاية سيان. وإنما ترضى وأنت في جوار ربك أنك غرست الفسيلة في الأرض ولم تدعها من يدك يقتلها اليأس والإهمال. * * * ليست إذن دعوة في الخيال حين يقول الرسول صلى الله عليه وسلم للناس: "إن كان في يد أحدكم فسيلة فليغرسها". وإنما هي صميم دعوة الحق. الحق الواقع في الأرض، المشهود على مدار التاريخ. والدعاة في كل الأرض أحوج الناس إليها حين تضيق بهم السبل ويصل إلى قلوبهم سم اليأس القتال. وهم أولى الناس أن يتدبروا سيرة الرسول نفسه. لقد كان يغرس الفسيلة وهو ما يدري ما يكون بعد لحظات! قد تأتمر به قريش فتقتله. قد يهلك جوعاً في الشعب هو ومن معه من المؤمنين. قد يلحق به الكفار وهو في طريقه إلى الغار فلا يكون ثمة غد.. أو تكون القيامة بعد لحظة.. ومع ذلك يغرس الفسيلة، ويتعهدها بالرعاية حتى يؤذن الله بالثمار، وهو مطمئن دائماً إلى الله ما دام يؤدي الواجب المطلوب. ذلك هو المثل الذي يحتاج الدعاة إلى أن يقتدوا به حين يدعون إلى الإصلاح. من كان في يده فسيلة فليغرسها! ولا يسأل نفسه: كيف تنمو وحولها الرياح والأعاصير والشر من كل جانب؟ لا يسأل نفسه، فليس ذلك شأنه.. فليدع ذلك لله ولتطلب نفسه أنه أودعها مكانها الحق، وعهد بها إلى الحق الذي يرعاها ويرعاه. ـــــــــــــــــــ [1] ذكره علي بن العزيز في المنتخب بإسناد حسن عن أنس رضي الله عنه. " عمدة القارئ في شرح صحيح البخاري لبدر الدين العيني، باب الحرث والزراعة ". [2] جاء في إحصاء طبي أن عشرة في المائة من الأمريكيين مصابون بالصداع الدائم كمرض، أي أنه ليس الصداع الطارئ الذي تشفيه المسكنات، وإنما هو صداع دائم لا يشفى! ثم قال التقرير إن هذه النسبة آخذة في الارتفاع. [3] سورة القصص [ 77 ]. [4] سورة الأعراف [ 32 ].
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الإشارات المرجعية |
| مواضيع ذات صلة | |
|
![1- قبسـات مِن الرسول [المقدمة والحديث الأول "فليغرسها"] Navbit10](https://i.servimg.com/u/f18/13/93/21/45/navbit10.gif)

![1- قبسـات مِن الرسول [المقدمة والحديث الأول "فليغرسها"] Jb12915568671](https://2img.net/r/ihimizer/img406/1933/jb12915568671.gif)








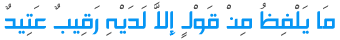
![1- قبسـات مِن الرسول [المقدمة والحديث الأول "فليغرسها"] Collapse_thead](stel-wlaef-aktalgmar-b/buttons/collapse_thead.gif)
